برهامي
الحمد لله، والصلاة والسلام
على رسول الله، أما بعد؛
فهذه الجملة العظيمة التي كان رسول الله -
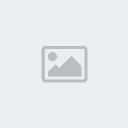 - يكررها في خطبة الحاجة وغيرها على مسامع صحابته -رضوان الله
- يكررها في خطبة الحاجة وغيرها على مسامع صحابته -رضوان اللهعليهم- فتحدث أثرًا تربويًا هائلاً في شخصياتهم، والتي نسمعها ونكررها في
دروسنا وخطبنا، هل أحدثت فينا مثل هذا الأثر؟!
هل استحضرنا معانيها وشهدنا حقائقها؟
هل استشعرنا -صدقـًا- أن في نفوسنا
شرورًا -بالجمع- لابد أن نلجأ إلى الله
-تعالى-، ونعتصم به ليخلصنا منها، وأن في
أعمالنا سيئات لابد أن نفر إلى الله منها، وهي بمنزلة العدو الذي يريد
أذانا، ونحن نفر ونحتمي بالله منه؟!
أم أن نظرتنا لأنفسنا على أنها صاحبة
الخيرات، وأن أعمالنا كلها صالحات، وأن آراءنا دائمًا هي الصواب، وأن من
خالفنا هو المخطئ دائمًا؟!
وكأننا إذا أقامنا الله في نصرة دينه
والدعوة إليه -وهذا من أعظم الفضل والمنة- قد أخذنا صكًا على بياض بصحة كل
الأعمال وسلامتها من الآفات؟!
إن القرآن قد أدَّب الصحابة -رضي الله عنهم-
ورباهم، والأمة من بعدهم على أننا من قـِبَل أنفسنا نـُؤتى؛ قال الله -تعالى-: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ
فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) (الشورى:30)، وقال -سبحانه- للصحابة لما أصابهم ما أصابهم في غزوة أحد: (أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ
أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ
أَنْفُسِكُمْ) (آل عمران:165)، وإنما قال هذا لمن بقي مع النبي -
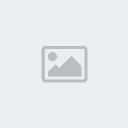 - في الغزوة،
- في الغزوة، وليس للذين رجعوا مع عبد الله بن أبي ابن سلول لما رجع بثلث الجيش، وقال
لهم أيضًا وهم خير من صحب الأنبياء: (مِنْكُمْ مَنْ
يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ) (آل عمران:152)، ومع أن
الذين يريدون الآخرة منهم فيهم رسول الله -
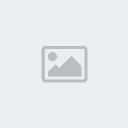 -، وأبو بكر
-، وأبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- وغيرهم من أمثال الجبال، وأثبت إيمانـًا، وصدقـًا،
وإخلاصًا، وثباتـًا على الدين؛ إلا أن وجود طائفة تريد الدنيا ممن تركوا
أماكنهم وقالوا: الغنيمة، الغنيمة؛ أدى إلى حصول الهزيمة، والمحنة،
والبلاء.
ولنتأمل في قوله -تعالى-: (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ
وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ
مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ) (التوبة:117)، فبعد كل ما
قدموه من السبق إلى الإسلام، والهجرة، وفيهم من شهد بدرًا، والحديبية،
وسائر المشاهد كلها، بعد كل هذا كاد يزيغ قلوب فريق منهم، فليس لأحد أن يظن
أن ما سبق له من عمل صالح من ذكر، أو عبادة، أو علم، أو دعوة، أو جهاد،
بعاصم له من الفتنة والمحنة، بل لا يعصم من ذلك إلا الله.
فهل نفتش في أنفسنا وقلوبنا عن إرادة
الدنيا؛ لنتخلص منها؟! مع أن أعمالنا ليست كأعمال هؤلاء، ولا إيماننا
كإيمانهم؛ فهم في النهاية أصحاب النبي -
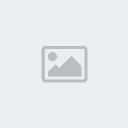 -، ولقد عفا
-، ولقد عفا الله عنهم، فكم يؤتى المسلمون من قـِبَلنا، وبسببنا، وكم تتأخر الدعوة بسبب
إهمالنا لأحوال قلوبنا، وكم يتناحر المسلمون فيما بينهم، بل ويقتتلون،
ويسفك بعضهم دماء بعض بتأويلات ظاهرها الحرص على الدين، وباطنها البغي
والحسد، والتنافس على الدنيا.
إن من أعظم ما يستطيع المرء أن يفتش
عن نفسه به، ويستخرج عيوبها ليتخلص منها: الصلاة، وتلاوة القرآن فيها،
والتضرع لله -سبحانه-، وسؤاله، ودعاؤه، وكذلك الصبر والثبات على المنهج
الحق؛ فليس معنى مراجعة النفس والتفتيش عن عيوبها التراجع عن الحق الذي دل
عليه الكتاب والسنة، والذي يظن كثير من الناس أنه السبب الذي ينزل البلاء
به؛ لأنه يرى الأعداء يرموننا بكل سهامهم نحوه فيقولون: فلعلنا لو تركنا
هذا لكفوا عنا!! وهم والله لا يكفون عنا إلا إذا تركنا ديننا: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى
تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ
اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ
مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (البقرة:120)، بل الصبر على
الحق والثبات عليه هو من أعظم أسباب النصر، ورفع البلاء ودفعه، واستحضار
دفاع الله عنا.
ولنتأمل هذه الأوامر الربانية
للمؤمنين: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ . وَلا
تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ
وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ . وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ
وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُولَئِكَ
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُونَ) (البقرة:153-157).
فنحن بحاجة شديدة إلى أن نصلي
كثيرًا، ونسبح كثيرًا، ونذكر الله كثيرًا، بحاجة إلى الصبر على الطاعات،
وعن المعاصي، وعلى ما يصيبنا من بلايا بسبب التزامنا طريق الحق أو بغير
ذلك؛ فإن الدنيا لا تخلو من البلاء لأحد مؤمن أو كافر، بر أو فاجر، وفي
الصلاة نوهب العطايا، وينزل الله علينا الرحمات والتي من أعظمها الهداية
إلى العيوب، والإعاذة من شرور النفس، وسيئات الأعمال.
فنتأمل في قول الله -تعالى- للمؤمنين
في ذكر غزوة بدر: (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ
فَاسْتَجَابَ لَكُمْ) (الأنفال:9)، ولقد بات رسول الله -
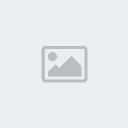 - ليلة بدر طول
- ليلة بدر طول الليل قائمًا يصلي تحت شجرة يبكي، ويستغيث ربه -عز وجل-، وكذا كان ليلة
الأحزاب؛ ليلة أرسل الله عليهم الريح والجنود التي لم يروها، يصلي هويًا من
الليل ثم يصلي، ثم يصلي... إلى الفجر.
أعدت مريم -عليها السلام- لما أراد
الله -تعالى- من البلاء، ثم الكرامة بالصلاة: (وَإِذْ
قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ
وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ . يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي
لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) (آل عمران:42-43).
وهب الله يحيى لزكريا -عليهما
السلام- وهو قائم يصلي في المحراب: (فَنَادَتْهُ
الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ
يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى) (آل
عمران:39).
قد تشغلنا مشاغل الحياة،
وأحيانـًا مشاكل الدعوة عن نصيبنا لأنفسنا، فنضع نصيبنا في آخر في سلم
الأولويات، وغالبًا ما تأتي الأولويات السابقة عليه فلا يبقى منه شيء؛
فتنمو الحشائش الضارة، بل والسامة في أرض القلب، وتزداد الأمراض، فتزداد
المشاكل، وتزداد المحن، ونحن في غفلة أن السبب من أنفسنا.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن
سيئات أعمالنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها
ومولاها.












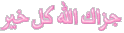









 مرحبا بك معنا ضيفا او عضوا عزيزا على منتدى اصحاب مدى الحياه. يمكنك المشاركة في المنتدى عن طريق تقديم المقالات والمواضيع المفيدة والردود البناءة. منتدى اصحاب مدى الحياه هو منتدى عربى مصري [ للحوار والنقاش ] و [ تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات ] و [ معرفة الجديد والمفيد ] و [ الأخبار العامة والمنوعة ] ، عالم جديد من الترفيه والمتعة، هدفنا نشر الافاده ، « هذا المنتدى حوارى وليس لتحميل الاغاني والبرامج والافلام المسروقة » .منتدى اصحاب مدى الحياه من المنتديات التي تحترم حقوق الملكية الفكرية ولا تساهم في نشر اي محتوى مسروق، لذا اذا صادف ان واجهت اي موضوع او مشاركة تخرق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك انت شخصيا يرجى تبليغ الادارة عبر نموذج
مرحبا بك معنا ضيفا او عضوا عزيزا على منتدى اصحاب مدى الحياه. يمكنك المشاركة في المنتدى عن طريق تقديم المقالات والمواضيع المفيدة والردود البناءة. منتدى اصحاب مدى الحياه هو منتدى عربى مصري [ للحوار والنقاش ] و [ تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات ] و [ معرفة الجديد والمفيد ] و [ الأخبار العامة والمنوعة ] ، عالم جديد من الترفيه والمتعة، هدفنا نشر الافاده ، « هذا المنتدى حوارى وليس لتحميل الاغاني والبرامج والافلام المسروقة » .منتدى اصحاب مدى الحياه من المنتديات التي تحترم حقوق الملكية الفكرية ولا تساهم في نشر اي محتوى مسروق، لذا اذا صادف ان واجهت اي موضوع او مشاركة تخرق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك انت شخصيا يرجى تبليغ الادارة عبر نموذج  الاعلانات النصية لشبكة ومنتديات اصحاب مدى الحيـاه
الاعلانات النصية لشبكة ومنتديات اصحاب مدى الحيـاه 
